السيناريست عماد النشار يكتب : استفيلوا يرحمكم الله
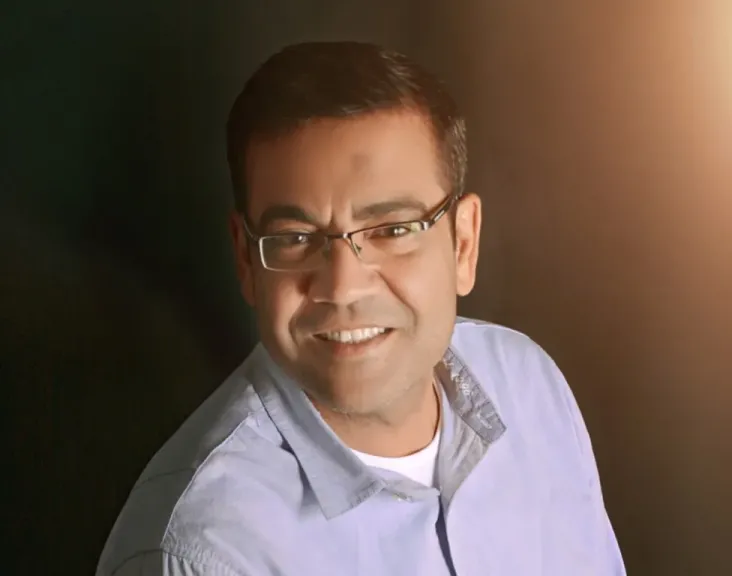

في زمنٍ يعلو فيه الصخب، وتضيع فيه الأصوات الهادئة خلف ضجيج القوة والسيطرة، هناك من يذكّرنا أن الرحمة ليست ضعفًا، وأن العظمة لا تُقاس بالحجم ولا بالسطوة، بل بما يسكُن القلب من وعيٍ وضمير. أحيانًا، يأتي هذا الدرس من كائنٍ لم يتكلم لغتنا، لكنه فهمنا أكثر مما نفهم أنفسنا — من فيلٍ عظيمٍ علّم العالم كيف يمكن أن تكون القوة مغموسة بالرقة، وكيف تنكسر الطبيعة حين يُساء إليها.
في السماء العالية، حيث تُحلّق الطائرات عابرة المحيطات، يحدث مشهد عجيب لا يتخيله أحد.
عندما يقرر الإنسان نقل فيلٍ من قارة إلى أخرى— لا يضعونه في القفص وحده. بل يرافقه في الرحلة كائنات صغيرة، عبارة عن كتاكيت ، لا تكاد تُرى بين ثنيات الأرضية المعدنية.
ليس ذلك عبثًا ولا زينةً، بل حيلة مدروسة.
فالفيل، رغم ضخامته التي تزلزل الأرض حين يخطو، يحمل في قلبه من الرقة ما يجعله يخاف أن يطأ كتكوتًا ضعيفًا تحت قدميه. لذلك يظل ساكنًا، متجمدًا في مكانه طوال الرحلة، لا يتحرك خشية أن يُؤذي تلك الأرواح الصغيرة.
وفي هذا الثبات الرحيم، تستقر الطائرة، ويمضي الجميع في أمان.
إنها لمحة خاطفة من شهامةٍ نادرة، لا تُقاس بالحجم، بل بالضمير.
لقد حيّر الفيلُ العلماء بما بدا في سلوكه من عقلٍ واتزانٍ وتعاطف. ففكّكوا أدمغته بحثًا عن السر، فاكتشفوا وجود خلايا عصبية لا يملكها إلا قلة من الكائنات — تُدعى الخلايا المغزلية — وهي نفسها التي تميّز الإنسان، وتجعله قادرًا على الوعي بالذات، والإحساس بالآخرين، وفهم الروابط الاجتماعية.
هكذا أدركوا أن الفيل ليس مجرد جسدٍ عظيم، بل نفسٌ راقية تعرف الحياء والرحمة والوفاء.
أما ليوناردو دافينشي، الفنان والعالم الذي أبصر الجمال في كل كائن حي، فقد كتب عن الفيل بعبارات تكاد تكون صلاةً في مديحه: "إنه مستقيم، رزين، معتدل الطباع، يغتسل في النهر كأنه يتطهّر من الآثام، يسير في جماعاتٍ منظمة يتقدمها قائد، لا يتزاوج إلا ليلًا بعيدًا عن الأنظار، ثم يعود بعد أن يغتسل، وإن صادف ماشيةً في طريقه، أزاحها بلطفٍ بخرطومه حتى لا يؤذيها."
إنه مخلوق يعرف حدوده، كأنه يدرك أن القوة لا تكون حقيقية إلا إذا اختلطت بالرحمة.
غير أن الرحمة لا تسكن جميع القلوب.
في الثالث عشر من سبتمبر عام 1916، دوّى في أمريكا حدث غريب، كأنما الطبيعة انتقمت من نفسها.
كانت هناك فيلة تُدعى ماري، بطلة السيرك، محبوبة الجماهير، رقيقة الطبع مطيعة الأوامر.
لكن القدر سلّمها ذات يوم إلى مدرّب جديد يُدعى ريد، رجلٍ لم يعرف من التدريب إلا العصا والعنف.
في الحادي عشر من سبتمبر، كان السيرك يتنقل بين المدن لاستعراض عروضه.
وفي إحدى الفقرات، حاول ريد أن يُجبر ماري على السير، فضربها أول مرة بعصا، ثم وخزها بأداةٍ حادة.
وللمرة الثالثة، حين اخترقت الآلة لحمها، ثارت الفيلة المسالمة.
مدّت خرطومها، التقطت جذع شجرةٍ قريبة، وضربته بها على رأسه.
سقط الرجل صريعًا، واستيقظت الوحوش في قلوب الناس.
لم يروا في المشهد صرخةَ ألمٍ، بل جريمة.
ولم يسأل أحدٌ عن السبب.
قرروا أن يعدموها شنقًا أمام الحشود، كأنهم يُقيمون عدالةً زائفة أمام الناس.
وفي يومٍ كئيب، تجمّع الآلاف، ورُبطت ماري بسلاسل الحديد، وارتفع جسدها الثقيل في الهواء، يتأرجح كظلٍّ حزينٍ بين الأرض والسماء.
وحين سكنت بعد الألم، اكتشفوا الحقيقة التي تجاهلوها:
كانت جروحها تملأ جسدها، بعضها قديم وبعضها جديد...
كانت ضحيةً للإنسان، لا مجرمةً في حقه.
لقد علّمتنا ماري درسًا يوجع أكثر مما يُقال:
أن الكائنات الطيبة حين تُقهَر وتُهان، تُصبح غضبتها الأخيرة أشبه بعاصفةٍ لا تُبقي ولا تذر.
وأن الصبر الجميل، حين يُستنزف، يتحول إلى قوةٍ لا يمكن التنبؤ بها.
فلا تختبروا طيبة من اعتاد أن يحتمل.
فاليوم الذي ينهض فيه بعد صمتٍ طويل، قد يُفقدكم أشياء أثمن من الغضب نفسه.







